- فريق التحرير - وصال الحياة
- August 16, 2025
- الصحة النفسية
الإسقاطات النفسية: عندما يمارس الإنسان ا...
الإسقاطات النفسية: عندما يمارس الإنسان الإسقاطات على نفسه من خلال الشاشات
المقدمة
في عصر المنصات الرقمية، أصبحت مفاهيم الصحة النفسية حاضرة بكثافة على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، لكن من المؤسف أن الكثير منها يُقدَّم على يد صُنّاع محتوى غير متخصصين، يسعون لجذب المشاهدات عبر تبسيط مفرط أو استخدام غير دقيق لمصطلحات نفسية حساسة مثل: "الشخصية النرجسية"، و"العلاقات السامة"، و"الاضطراب الحدّي"، وغيرها.
الخطورة تكمن في أن المتابع، دون خلفية معرفية كافية، يبدأ بإسقاط هذه المفاهيم على ذاته أو محيطه، مما يؤدي إلى حالة من التشويش النفسي، ويُضعف إدراكه لذاته وللواقع من حوله. بل قد تتعدى الأثر الفردي لتشمل تفسخًا تدريجيًا في بنية العلاقات، خاصة حين يُصبح كل اختلافٍ أو سلوكٍ بشري طبيعي مؤشراً على اضطراب مزعوم أو تصنيف مرضي.
في هذا المقال، نستعرض ماهية الإسقاطات النفسية، وآلية تشكلها، والأضرار الناتجة عنها، ثم نختم بسبل الوقاية والتعافي منها، مع التوسّع في تفكيك الخلفيات النفسية والاجتماعية لهذه الظاهرة التي باتت تتخذ طابعًا وبائيًا رقميًا.
ما المقصود بالإسقاط النفسي؟
الإسقاط في علم النفس هو آلية دفاعية لا واعية، يُسقِط فيها الفرد صفاته أو مشاعره أو نواياه على الآخرين، هرباً من مواجهتها في نفسه. وقد وصفها فرويد بأنها من أقدم الحيل النفسية التي يستخدمها العقل الباطن لحماية الأنا من إدراك جوانب لا يُحبّها في ذاته.
لكن في الواقع الرقمي، بدأ هذا المفهوم يكتسب بعدًا جديدًا؛ إذ لم يعد الإسقاط محصورًا في تحويل مشاعر مكبوتة إلى الآخر، بل امتد ليشمل تبني تصنيفات جاهزة تُعرض على هيئة محتوى مرئي، يُستهلك بسرعة، ويتحول لاحقًا إلى مرآة مُشوّهة يرى الإنسان فيها ذاته.
أمثلة شائعة:
- شخص يشاهد مقطعًا عن النرجسية، فيبدأ بوصف نفسه أو شريكه بالنرجسي، دون فهم للمعايير التشخيصية المعقّدة.
- آخر يرى منشورًا عن العلاقات السامة، فيفسّر أي خلاف طبيعي أو حاجة للحدود الشخصية على أنه دليل على سُمِّية العلاقة.
- مستخدم يقرأ عن اضطراب الشخصية الحدّية، فيظن أن انفعالاته العابرة دليل على اضطراب نفسي، رغم أن ما يشعر به قد يكون انعكاسًا لضغوط يومية أو عدم نضج عاطفي.
هذه الأمثلة لا تشير فقط إلى اختلاط الفهم، بل تكشف عن نوع من الهروب النفسي أو محاولة تبسيط المعاناة الفردية عبر تبنّي تصنيفات مريحة تعفي صاحبها من التفسير العميق أو طلب المساعدة.
لماذا تحدث هذه الظاهرة؟
1. العدوى النفسية الجماعية:
عندما يتكرر ظهور مصطلحات معينة في أكثر من منشور أو مقطع، يبدأ المتابع في تبنّيها، معتقدًا أنها تنطبق عليه. هذا ما يُعرف في علم النفس بـ"العدوى النفسية" أو (Psychiatric Contagion)، وهي ظاهرة موثقة ترتبط بتأثير المعلومات النفسية المنتشرة عبر المجتمعات أو المنصات، لا سيما بين فئات عمرية أصغر أو أقل وعيًا. وتزداد حدّتها حين يترافق المحتوى مع تعاطف عاطفي قوي أو استخدام قصص واقعية تبدو مشابهة لحياة المتلقي.
2. تحيّز التوافر:
الدماغ يميل إلى استخدام المعلومة الأكثر حضورًا في الذاكرة. فعندما يرى المستخدم محتوى عن الاكتئاب أو اضطراب فرط الحركة، ويربطه بسلوك مرّ به، يظن تلقائيًا أن الحالة تنطبق عليه. ويعزز هذا النمط طبيعة المحتوى الذي يُعاد تداوله بكثرة في المنصات، مما يجعل المصطلحات النفسية الشائعة كأنها القاعدة لا الاستثناء.
3. المقارنة الاجتماعية:
وفقًا لنظرية المقارنة الاجتماعية، يكوِّن الأفراد تقييمهم لذاتهم من خلال مقارنة أنفسهم بالآخرين. وعبر السوشيال ميديا، تتم هذه المقارنات بشكل غير عادل، لأن ما يُعرض ليس إلا لحظات مُنتقاة بعناية، تُظهر "المثالية المزيفة" في العلاقات والمظهر والإنتاجية، فيشعر المتابع بالنقص أو الفشل، فيُرجع ذلك إلى خلل نفسي افتراضي.
4. العلاقات الوهمية (الباراسوشال):
المتابع يشعر وكأنه على علاقة شخصية مع صانع المحتوى، ويتلقى منه المعلومات وكأنها مشورة متخصصة. هذه العلاقة من طرف واحد تُسمى في علم النفس "باراسوشال"، وتُعد من أخطر علاقات التأثير المعاصر، لأنها تخلق ثقة غير مدروسة في مصدر المعرفة، وتُضعف القدرة على النقد والتحليل.
5. البحث عن الهوية النفسية:
الجيل الجديد، خاصة المراهقين والشباب، يعاني من فجوة في فهم الذات وتحديد الهوية النفسية. في غياب التربية النفسية العميقة أو الحوارات الأسرية الآمنة، تُصبح المصطلحات المنتشرة على المنصات وسيلة سهلة لتفسير الذات وفهم المشاعر، لكنها تخلق هوية مُشوّهة وغير دقيقة.
كيف تتشكل الإسقاطات؟
1. اللقاء الأولي بالمصطلح: يبدأ الأمر برؤية منشور أو مقطع يشرح مصطلحًا نفسيًا بأسلوب مبسّط وجذاب.
2. الربط الذاتي السريع: يتذكر المتابع تجربة سابقة مشابهة جزئيًا، فيشعر أن الوصف ينطبق عليه.
3. التعميم: يبدأ في تفسير مواقف متكررة على أنها أدلة داعمة على انطباق الحالة عليه.
4. تثبيت الهوية: يتبنّى المصطلح كجزء من تعريفه لذاته، ويبدأ في التحدث عن نفسه بلغة تشخيصية. يتغير حديثه مع الآخرين: "أنا أعاني من التعلق المرضي"، "أنا شخص نرجسي"، أو "أنا مصاب بالاضطراب الحدّي".
5. إعادة تأكيد الإسقاط من البيئة: في بعض الحالات، تبدأ البيئة المحيطة بتعزيز هذا الإسقاط، من خلال التعاطف أو إعادة التوصيف، مما يجعل الشخص أكثر التصاقًا بالمصطلح، ويضعف رغبته في التحليل الموضوعي.
6. تأثير ذلك على النفس والعلاقات: يبدأ الشخص في تفسير سلوك الآخرين أيضًا من زاوية تشخيصية: "زوجتي توكسيك"، "أبي نرجسي"، "مديري يعاني من التعلق القلق". يتآكل بذلك الفهم الإنساني الطبيعي لصعوبات الحياة، ويُختزل الوعي في قوالب نمطية، تضر أكثر مما تنفع.
7. الأثر النفسي والاجتماعي
- تشويش في الهوية: يُصبح الفرد غير قادر على التمييز بين مشاعره الحقيقية والتوصيفات المشاعة عبر السوشيال ميديا.
- ضعف المرونة النفسية: فبدلاً من التعامل الطبيعي مع التقلّبات المزاجية، يُفسّر كل شيء على أنه مرض. يقلّ التسامح مع الذات وتزداد مشاعر العجز.
- تثبيت دور الضحية: تتعزز الهوية الضحية في العقل، حيث يشعر الفرد أنه يعاني من اضطراب غير قابل للتغيير، مما يقلل من روح المبادرة والمسؤولية الذاتية.
- توتر العلاقات: عندما تُفسَّر الخلافات الزوجية أو الأسرية أو المهنية من خلال مصطلحات مرضية، تُهمل فرص الحل والنمو. يُصبح النقاش مشلولًا، لأن الطرفين يريان نفسيهما من خلال عدسة التشخيص لا الإنسانية.
كيف نقي أنفسنا من هذه الإسقاطات؟
أولاً: الفلترة الواعية للمحتوى
- لا تتلقَّ المعلومات النفسية إلا من متخصصين معروفين.
- لا تُصدّق كل محتوى قصير يُعرض بشكل جذاب، خاصة إذا لم يُدعّم بمصادر علمية أو أدلة موثوقة.
- تابع الصفحات التي تُركّز على التثقيف العميق لا الإثارة والتشخيصات السريعة.
ثانيًا: مراجعة الذات بهدوء
- اسأل نفسك: هل حقًا تتكرّر لديّ هذه الأعراض؟ أم أنني تأثرت بلحظة انفعالية؟
- دوّن ما تمر به بشكل موضوعي لمدة أسبوعين، ثم قارنه بالمعايير العلمية الحقيقية لأي اضطراب نفسي.
ثالثًا: استشارة المختصين
- في حال الشك أو التوتر النفسي المتكرر، لا بد من مراجعة معالج نفسي معتمد.
- التشخيص الدقيق لا يتم عبر مقطع فيديو أو اختبار على الإنترنت، بل من خلال تقييم سريري متكامل.
رابعًا: تطوير مهارات التوازن النفسي
- مارس تمارين الوعي باللحظة (Mindfulness)، فهي تساعدك على ملاحظة مشاعرك دون أن تُضخّمها.
- استخدم الكتابة كأداة لتنظيم الأفكار، دون إطلاق أحكام على الذات.
- ركّز على تطوير مهارات العلاقات والذكاء العاطفي بدل البحث عن تصنيفات.
خامسًا: تعزيز الهوية المتوازنة
- بدلًا من تبنّي مصطلح نفسي كهوية، درّب نفسك على النظر للذات من خلال الإمكانيات لا النواقص.
- اعترف بمناطق التحدي فيك، دون أن تُلصق بها صفة مرضية. فكل إنسان يحمل مزيجًا من القوة والضعف، ولا يحتاج إلى هوية مشخّصة ليبرّر نفسه.
خاتمة
إن الإسقاطات النفسية الناتجة عن متابعة محتوى سطحي على السوشيال ميديا ليست مجرد خطأ معرفي عابر، بل قد تتحول إلى أزمة هوية واضطراب في العلاقات وتعطيل لمسار النمو الشخصي. ومع الانتشار المتزايد للمصطلحات النفسية على يد غير المختصين، صار لزامًا على كل متابع أن يتحلى بوعي نقدي، ويمتلك أدوات الفرز والتقييم، ويتوجه عند الحاجة إلى المتخصصين المؤهلين.
فهم الذات لا يأتي من متابعة الريلز أو اقتباس العبارات النفسية الرائجة، بل من تأمل عميق، وعلاقات حقيقية، وتوجيه متخصص يرافقك في طريق التوازن والتعافي.
لا تكتفِ بوصف نفسك، بل اسعَ لفهمها. ولا تُسقِط عليها ما ليس منها، فربما تكون بخير، لكنك فقط بحاجة إلى إصغاء أعمق، لا تشخيص أسرع.
———
فريق التحرير – وصال الحياة
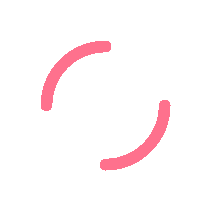
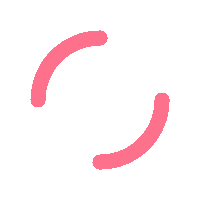


تعليقات